الصديقان اللدودان
.......................
في المراحل الدراسية الآولى(الصف الأول والثاني والثالث الإبتدائي( وفي أحيانٍ كثيرة ربما قلّت مع تقدّم الزمن ولكنها ما زالت قائمة ، يصعب على المدرسين اكتشاف الطلبة الأذكياء المتفوقين وفرزهم وتمييزهم عن الطلبة العاديين ، لذلك فإنه من الصعوبة بمكان أحياناً معرفة مستويات الذكاء الحقيقية للأطفال وتصنيف الطلبة على هذا الأساس، ومن الخطأ إطلاق الأحكام عليهم ووصمهم بصفات هذه الأحكام السابقة لأوانها من صغرهم لتكبر معهم وتحد من إنطلاقتهم وقدراتهم ، انطلاقاُ من المثل الشعبي القائل (الديك الفصيح من البيضة بصيح(، ويبرز ويظهر في تلك الصفوف الإبتدائية الآولى الطلبة الذين يتميزون بالجرأة والشجاعة وطلاقة اللسان وسرعة البديهة ومن يجيدون التمثيل وسرد الحكايات ، والنفاق الموجب (حيث أنهم ببراءتهم لا يعرفون بعد النفاق السالب)، وكذلك أصحاب النكتة والتهريج وهواة التمثيل والفن من ذوي المستويات المتوسطة من الذكاء ويتفوقون على الطلبة حادي الذكاء والذين يتميزون بالقلق والخوف والسرحان في ميادين خيالهم الواسع ، وعدم الجرأة والتسرع ، ويميلون للتحليل والإمعان قبل الكلام ، ويخشون المبادرة السريعة خوفاً من الوقوع بالخطأ والتعرض للعقاب ، ويتميزون بالذاكرة القوية والقدرة على التخزين والإستدعاء للمعلومات برويَّة ، وبحسن الإنصات والإستماع ، وبقلة الكلام والثرثرة والنزعة للعزلة في بعض الأحيان ، وإن نطقوا أو تكلموا أوجزوا وأوفوا بالمراد وكأنهم ينطقون حكما في كلام مختزل مركز كالأمثال الشعبية والحقائق العلمية والمعادلات الكيميائية الموزونة.
في الفاتح من (أيلول) عام 1957م دخل المدرسة للصف الأول الإبتدائي في إحدى قرى فلسطين طالبان من قريتين متجاورتين ومشتركتين في مدرسة واحدة ، هما (يوسف من قرية أ وعلي من قرية ب.( فما قصة هذين الطالبين اللذين أصبحا صديقين لدودين أثناء دراستهما معاً في فصل واحد من الصف الأول الإبتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي ، وها هما الآن قد افترقا وصارا من المتفوقين والمبدعين في علمهما وعملهما ونشاطاتهما الأدبية والثقافية.
بدأ يوسف حياته الدراسية بالنكد والبكاء والعناد لأهله ، لا يريد الذهاب للمدرسة ، إنه القلق والخوف من المجهول ، ففي هذا اليوم بدأ والده رحلة الى سوق الحلال بالمدينة مبكراً لبيع الخراف والجديان ، وكان أهله يقدمون له الحوافز ويستدرجونه للقبول خفية عن أخيه الأكبر لكي لا يسمعه فيضربه ضرباً شديداً لا يرحم ، فقد كان أخوه الأكبر الساعد الأيمن لوالده في توفير الرزق للعائلة ، وكان هو الحاكم للأسرة في غياب الأب ، وكان متسلطاً خالياً قلبه من الرحمة والعطف ، يضرب أخوته وأخواته بذنب وبدون ذنب ، وكان صاحب السطوة والقوة الجبارة التي لا تقاوم ولا يُعصى لها أمر.
في أول يوم دراسي أفاقت الأم يوسف من نومه ، فتظاهر بالمرض وبألم في رجليه لا يستطيع المشي ، فطلب يوسف منهم أن يوصلوه راكباً على الحمار مؤملاً أن لا يوافقوه ويستسلموا لرغبته في عدم الذهاب ، كما طلب منهم قرشين ليشتري أسكمو وحلقوم وحامظ حلو، وكان القرش في ذلك الزمان يعتبر مبلغاً باهظاً لمصروف طالب ، فشد أخوه الذي يكبره مباشرة بست سنوات البردعة على ظهر الحمار ، وأعطته أمه قرشاً واحداً ووعدته بالقرش الثاني عندما يبيض الدجاج، (حيث كانت العشر بيضات تُباع بعشرة قروش وقرش بحساب عجوزٍ كانت تبيع وتشتري البيض وترفض شراء العشرة بيضات بأحد عشر قرشاً، وتصر على أن العشرة ببريزة بيضاء وقرش أحمر)، واركبوه على الحمار خفيةً عن أخيه الأكبر ، وسار به أخوه حتى أوصله المدرسة ، ولما أنزله عن ظهر الحمار وأدار اتجاه الحمار يريد العودة للبيت ، أبى يوسف الدخول للمدرسة وأخذ يصيح باكياً ، فربط أخوه الحمار خارج سور المدرسة (حيث كان السور عبارة عن سنسلة حجارة( وأدخله محمولاً بين يديه ، وهو يرفس ويلوح بيديه يميناً ويساراً وبرجليْه للأعلى وللأسفل ، ويدفع أخاه بيديه ويخرمشه بأظافره ، ويرفض التقدم نحو جموع الطلبة ، فتناوله أحد المدرسين ممسكاً بيده بلطف مصطنع ، وقال لأخيه إرجع أنت وسنتولى نحن أمره ، وهنا ازداد صياحه وعلا صوته وانتفخت أوداجه ، فأمسكه المدرس من أذنه فشد عليها بين أصابعه وقرصها ، ولما اختفى أخوه عن الأنظار عائداً للبيت ، صفعه المدرس على خده وضربه بالعصاة على جنبيه ، وصاح به صوتاً أخافه وجمده مكانه ، فامتثل لأمر المدرس، ومشى معه مكرهاً تحت ضغط الخوف والرهبة ، ولكنه كان بنتفض من الداخل ويكبت في صدره بركاناً من الرفض والخوف والقلق والثورة ، ويحشر صياحه في حنجرته المنتفخة مانعاً له من الخروج ، وكانت دموعه الحارة تسحل على خديه كسح المطر في غياب العواصف وسكون الهواء ، وكان أنفه يسيل سعالاً ، فامتزجت دموعه مع سعاله ، وابتلت أرجل بنطاله من شدة الخوف ، وأخذ يمسح بيده عن خديه ليزيل هذا المزيج الذي يعبر عن الخوف والرهبة ، وبعد ذلك يمسح يديه المبتلتين في بدلته الكاكي الفضفاضة لكي تخدمه لأكثر من سنة (ثلاث سنوات على الأقل( ، ويمسح بيده الأخرى في شنطته التي خاطتها له أمه من كيس الطحين الفارغ من ماركة ممتاز، والذي كتب عليه (تقدمة من الشعب الأمريكي).
قرع الجرس واصطف الطلبة القدامى في طوابير ، وجمع المدرسون الطلبة الجدد في ساحة في جانب الملعب القريب من بناء المدرسة ، وكان عددهم آنذاك يتجاوز الأربعين طالباً من القريتين ، ولكن مبنى المدرسة والمباني المستأجرة لا تسمح بتوزيعهم على فصلين ، فوضعوهم في فصل واحد ، وكانت المقاعد الدراسية طويلة والفصول واسعة ، فكل مقعد يتسع لستة طلاب وأحياناً لأكثر من ستة طلاب ، كان حوالي عشرة تلاميذ من الأربعين يبكون ولا يريدون الإنخراط في هذا الوضع الجديد الذي فصلهم عن أمهاتهم وآبائهم وحد من حريتهم في اللعب والكلام والحركة وسط جو من الرعب ، حيث شاهدوا المدرسين يحملون العصي للتلاميذ وشاهدوا بأعينهم في اليوم الأول كيف يضرب المدرسون التلاميذ القدامى من الذين لا يلبسون بدلة الكاكي، والذين تأخروا عن الطابور، ومن كانت أظافرهم وشعورهم طويلة ، وقد تسامح المدرسون في اليوم الاول مع الطلبة الجدد استثناءً ، فكانت شعور بعضهم وأظافرهم طويلة وقسم كبير منهم لا يلبس بدلة الكاكي للفاقة والفقر ولزحمة العمل عند الخياط الوحيد بالقريتين.
دخل طلاب الصف الأول الى الفصل وأصوات البكبكة تنطلق من العشرة المخلفين في آخر الطابور ، وتم توزيعهم على المقاعد حسب الطول والواسطة ، أما الطلبة الذين كانوا يبكون فقد أُجلسوا جميعهم في المقعد الأخيرعقاباً لهم ، ودخل المدير الى الفصل عاقد الحاجبين مكشراً ومكفهر الوجه ، وألقى بتعليماته ونذره بالعقاب للطلبة الجدد وهو يلوح بعصاه غير الملساء وغير المهذبة حيث تظهر عقدها ونتوءاتها للطلبة كإنذار بشدة العقاب.
وقال المدير : اليوم سماح يا أولاد ، وغداً سوف نطبق عليكم قوانين المدرسة كمن سبقوكم اليها وكما رأيتم بأعينكم اليوم ، اسمعوني جيداً وطرق بعصاه على طاولة الأستاذ ، من يأتي وشعره طويل فسوف يكون عقابة عشرة عصي بهذه العصا ، ومن كانت أظافره طويلة فسوف يُضرب خمسة عصي على ظهر يد واحدة ، ومن يأتي ولم يلبس بدلة الكاكي فجزاؤه فلقة على رجليه أمام الطلبة في الطابور. وكان العشرة المخلفين الرافضين الأواخر ينتفضون خوفاً ورهبة ، وكان يوسف يجلس بجوار علي في المقعد الأخير ، فعلي أحضره أبوه للمدرسة ، ولكن من هو علي؟
كان أباه متزوجاً من اثنتين ، الزوجة القديمة أم أولاده الكبار الذين لم يدخلوا المدرسة ، والزوجة المعزوزة الجديدة أم علي والتي لم تُنجب غيره بعد وقت طويل من زواجها كادت فيه أن تفقد الأمل بالخِلفة ، فكان وحيد أمه ومدللاً من أبويه، وبالأخص من أمه ، فوجد صعوبة في فراقها والذهاب للمدرسة وكان حاله كحال يوسف في رفضه وعناده وبكائه وصراخه ، ولكن لم تُفرك أذنيه ولم يُصفع على خده ويُضرب بالعصا لوجود والده معه بناءً على توجيهات والدته صاحبة الصول والجول والكلمة ، وخلال وجود الطلبة بالفصل شعر علي بحاجته للعراء ، ولم يكن بالمدرسة دورة مياه حيث كان الطلبة يخرجون في الفسح بين الحصص لعراء قريب من المدرسة ويصطفون خلف سنسلة الكرم المجاور للمدرسة ويقضون حاجاتهم الخفيفة، أما الحاجة الثقيلة فكانت تتطلب عملاً شاقاً لتأديتها وتضع صاحبها في حرج كبير حيث يتطلب الأمر اعتلاءه للسنسلة وقضاء حاجته خلفها بعيداً عن الأنظار. في بداية شعور علي بالجاجة للعراء خاف من أن يطلب الإذن من الأستاذ للخروج لقضاء الحاجة ، واخيراً اضطر لطلب ذلك فرفع اصبعه بخجل وطلب بصوتٍ متهدج وهو يعصر جسمه، فصاح به الأستاذ يأنبه ويزجره ويطلب منه الإنتظار للفسحة ، فاستسلم للأمر وبلَّل بنطاله كجاره يوسف، ولمّا خرجا من الفصل تجمع حولهما الطلبة يسخرون منهم ويقهقهون على عملتهم السوداء ، وكان والد علي في الستين من عمره آنذاك وكانت أمه في الأربعين ، وكان إخوته غير الأشقاء ينبذونه ويكرهونه كإخوة سيدنا يوسف عليه السلام ، لأنهم كانوا يشعرون بتمييز والدهم وانحيازه لإبن ضُرَّة أمهم. لذلك لم يشعر علي بمشاعر الأخوة والإلفة والترابط الأخوي والأسري في البيت ، لقد كان معزولاً من إخوته لا يشركونه باللعب معهم بالرغم من وجود من يقاربه بالسن بينهم ، وكان فاقداً للأمن والأمان ، ويشعر بالإضطهاد من إخوته الكبار ، فكلما سنحت لهم فرصة الإنفراد به كانوا يحقرونه وأحياناً يضربونه . وكان يشتكي لأمه فتحرض أباه على أبنائه الآخرين فيضربهم وبالتالي يزيد حقدهم عليه وحبهم للإنتقام منه، وهكذا كانوا يعيشون في دوامة من العنف والعنف المضاد ودائرة من الفعل وردة الفعل ، لذلك كان جو المدرسة رهيباً ومخيفاً له لانعدام الأمن الإجتماعي والأمان في البيت، وكان يفتقد للأمن الأسري المتكامل المترابط ويعاني من نقصٍ في مشاعر الأخوة بعكس الفطرة البشرية ، كان يتمنى أن تلد له أمه أخاً أو أختاً ليكون كباقي الأولاد ، وليشكلوا له خيمة تحميه وتظلله وتدافع عنه عندما يخرج خارج البيت ، فكان يتعرض للضرب والإضطهاد من أطفال الحارة ولا يرى من يدافع عنه من إخوته بالرغم من استنجاده بهم ووقوفهم متفرجين عليه وهو يُضرب ويُهان ويُضطهد. فقد استوطى الأطفال حائطه وكانوا يفرغون بطولاتهم المزعومة وشقائهم به ، مما اضطر والدته أن تمنعه من الخروج الى الحارة للعب مع الأطفال ، فحرم من الطفولة ولهوها، فتولدت لديه عقدة العزلة وتعود عليها وصارت سمةً من سماته مما جعله يشعر بالخوف إن خرج بعيداً عن والدته التي كانت تخاف عليه من نسمة الهواء لشعورها بأنه سيكون سندها في المستقبل سيما وأن زوجها الذي يكبرها بعشرين عاماً يقترب من نهاية العمر وهي ما تزال صغيرة.
ونعود الى التعريف أكثر بالبطل الآخر للقصة، أما يوسف فقد كان ترتيبه العاشر بين إخوته وأخواته الخمسة عشر ، والذين مات منهم خمسة بالحصبة وبقي عشرة على قيد الحياة لم ينل الكبار منهم فرصة التعليم ، فقد جاء يوسف للحياة في وقت ملَّ فيه الوالدان من الخلفة والخلف ، فقد كانت الأم تلد في كل عام ، وقد مات قبله مباشرة من الإخوة إثنان وبعده مباشرة من الإخوة إثنان ، لذلك كان العائلة تتشاءم منه ومن فاله السيء ، وكانوا يلقبونه أبو سعد )الغراب( وأحياناً كانوا ينادونه يا "غراب البين." وقد دهمته الحصبة في صغره مع اثنين من إخوانه وكان هو أوسطهم سناً ، وكان أضعفهم بنياناً وأكثرهم اعتلالاً ونالت منه الحصبة كثيراً ، وكانت الأسرة تتوقع أن تأخذه الحصبة بجرائرها كعادتها في كل عام ، وينجو منها أخواه ، ولكن ما حدث هو أن مات اخواه وبقي هو النحيل المنهك على قيد الحياة ، كان نحيلاً ضعيف البنية أصفر اللون وكان مهملاً ويعاني من سوء التغذية وقلة الرعاية. لم يكن يوسف كغيره من الأطفال يشعر بحنان الأب الذي كان منهمكاً بتدبير لقمة العيش لهذه العائلة الكبيرة وكان يعمل بتجارة المواشي ويرتاد سوق الحلال بالمدينة مشياً على الأقدام أو ركوباً على الحمير ، فكان يغيب كثيراً عن البيت والأسرة ، ولم تكن أمه ترويه بالحنان لإنشغالها بتدبير الطعام والقوامة في غياب الزوج ولكثرة همومها ومهامها ، وانشغالها في موسم الحصاد والدرس وجمع الزبل للطابون ونقل المياه على رأسها للشرب والعجين والخبيز والطبيخ والنفيخ، وحلب البقر والأغنام وتحضير اللبن والزبدة والجبن ، وتربية الطيور من دجاج وحمام ، ولكثرة أبنائها وتتابعهم الموسمي السريع دون أن يأخذ الطفل حقه من الرعاية والحنان ، وكانت تقاسم زوجها بل تزيد عنه في بذل الجهد والعرق والكد والتعب من أجل توفير قوت الحياة لأولادهم ، وكذلك كان إخوته الكبار والذين حُرِموا من التعليم يشرفون على الأرض ويقومون بأعمال الفلاحة بحرث الأرض وزراعتها ، والحصاد والدرس ورعي البقر والغنم ، فكانت كل هذه الجهود لم تكن قادرة على توفير بحبوحة من العيش نظراً لسوء الأوضاع الإقتصادية والسياسية في ذلك الوقت. فتربى يوسف مهملاً مهمشاً لا يأبه به أحد ، منعزلاً وفاقداً للحنان والأمن الأسري ، كان يعمل مع العائلة في رعي الغنم والبقر وفي نقل الحصاد الى البيد\ر (الجرون( ورعاية المقاثي والكروم ، وفي الدرس والتخزين ، يفيقونه من النوم مبكراً أيام الحصاد صيفاً ، وأيام البرد شتاءً لرعاية الأغنام بحذاءٍ مخيط ورقيق (كوشوكة)، وكان الحذاء مثقوباً ويضع في الثقب كرتونة، ويلبس لباساً لا يقيه البرد ويحمل كسرة من الخبز يغمسها بالحليب من النعاج أو الماعزوهو سارح يرعى الغنم ، وكان حينها لم يبلغ السادسة من عمره بعد. لذلك شعر يوسف بالرهبة والخوف من جو المدرسة الضيق والمحصور والمحتشد بالتلاميذ على مختلف الأنماط، ومن تحذير ونذر المدير والمدرسين ومن الطلاب ممن يكبرونه سناً.
جمعتهما (يوسف وعلي( عوامل وقواسم مشتركة في المدرسة وفي الأيام الآولى منها بالتحديد ، إنها عوامل الرهبة والخوف والبكاء والرفض ، فشعر كل منهما بمقاسمته للآخر في مشاعره ، وأدى ذلك الى إلفة وشعور بالتقارب ونوع من الأمن المشترك على الرغم من اختلاف اهتماماتهما وميولهما، فكان كل واحد منهما يمثل عزاءً للآخر ، وربط بينهما خيطاً واهناً ورفيعاً من الصداقة والتقارب على قاعدة واهنة من الصفات والميول، حيث جمعتهما صفات خوفٍ وضعفٍ لا تشرِّف صاحبها ، ومن منطلق المصلحة المتبادلة استلطف كل منهما الآخر، وكان بيتاهما متقاربين ، فصارا يذهبان للمدرسة ويعودان منها معاً ، يخرج يوسف الى بيت علي ثم ينضم اليه علي في ذهابهما وإيابهما من المدرسة. وكان يجمعهما نظرة المدرسين المتشابهة لهما ، فقد نُظِر اليهما أنهما الطالبين الكسولين واللذين لا يشاركا بالفصل ، هذا علاوة عن اضطهاد الطلبة لهما من تعليقات المدرسين عليهما ووصفهما بالغباء والبلادة والضعف والخوف.
اتفقا ذات يوم على خداع أهلهما وعدم الذهاب للمدرسة خوفاً من المدرسين وتعليقاتهم ومن الطلبة واستهزائهم خلال الفسح ، فقضيا اليوم في كرم قريب من المدرسة ولما عاد التلاميذ لبيوتهم عادا الى بيتهما وكأنهما داوما كغيرهم من الطلاب. وتكرر الغياب الى أن جاء في ذات يومٍ صاحب الكرم ليتفقد كرمه ، ووجدهما يعبثان بالثمار والزرع ، فاشتكى لأهلهما وانكشف أمرهما ، ونالا عقاباً من اهلهما ومن المدرسة . فكانت نتائجهما في السنة الآولى متقاربة جداً ، يوسف احتل الترتيب الخامس والثلاثين على الفصل وعلي السادس والثلاثين من أربعين. ولمّا لم يجدا منفذاً لترك الدراسة بدءا يتأقلمان تدريجياً على الجو الجديد ، وفي السنة الثانية تحسنت نتائجهما فأحرز يوسف الترتيب السابع عشر وعلي الترتيب العشرين ، وبدأ المدرسون يكتشفون قدراتهما الدراسية المخبأة وغير المستثمرة تدريجياً ، وفي السنة الثالثة نال يوسف الترتيب الخامس وعلي الترتيب السادس على الفصل. وبدأ التلميذان يتحرران من قيود الخوف والرهبة تدريجياً مع مرور الزمن، وبدأ المدرسون يكتشفون المزيد من قدراتهم العقلية والذهنية، ويطرون عليهما بحل المسائل الصعبة في الرياضيات وسرعة حفظ النشيد والمحفوظات وسور القرآن الكريم. وفي السنة الرابعة )الرابع الإبتدائي( قفز يوسف للمرتبة الآولى وعلي للمرتبة الثانية. ودخلت علاقتهما طوراً جديداً ومختلفاً ، إنه التنافس الحاد والمطاردة لنيل المرتبة الآولى. فقد كان الحكم في السنوات الثلاث الآولى على التقييم الشفوي للطلبة والجرأة في رفع الإصبع للإجابة، ولمّا بدأ التقييم التحريري بالإمتحانات ظهرت قدراتهما الذهنية والعقلية على ورق الإمتحان بعد أن تحررا من الضغوط ، وتفاجأ المدرسون بمستواهما التحصيلي والعلمي ، وكأنهما كانا مخبئين في قشورهما. قشور الخوف والرهبة التي غلفت لبيْهما وعقليْهما وربطت لسانهما عن الإنطلاق لشدة حرصهما من الوقوع في الخطأ ثم العقاب ولشدة حرصهما على صحة ما ينطقون به.
كان يوسف يمتاز بالذاكرة القوية والذكاء الحاد ويتفوق على علي قليلاً بالمواد العلمية ، وكان علي يتفوق قليلاً بالمواد الأدبية ، وكل منهما كان مبدعاً في كلا الفرعين ، ولم يكن يوسف يجيد المناقشة والمشاركة في الفصل بعكس علي الذي كان يمتاز بالجلد وحب المطالعة ونهم القراءة والإنتباه للشرح ويتفوق على يوسف بالمشاركة بالفصل وبمواضيع الإنشاء . كان يوسف لا يحب المطالعة والدراسة ويؤجل كل شيء ليوم الإمتحان ويميل الى اللعب واللهو والشللية والعصابات الطلابية وعدم الإنتباه للشرح ، وظل علي محباً للعزلة والمطالعة خارج المنهاج ، فكان يقرأ القصص والروايات بنهم ، فقرأ قصص يوسف السباعي ونجيب محفوظ وعبد الحليم عبدالله كلها ، وكان يحضر الدروس ويتابع الشرح والمشاركة. أما يوسف فكان يعتمد في ثقافته على المنهاج والسمع ، وكانت له بدايات أدبية وشعرية واعدة في صغره نالت إعجاب المدرسين، فبدأ كتابة الشعر مبكراً معتمداً على الموهبة فقط ، لكنه لم ينمّ مفرداته ولغته العربية بالمطالعة والقراءة إنما بالإستماع وسعة الخيال والتأمل في الطبيعة وما يلتقطه من تعابير وجمل بالمنهاج . وبدأ بينهما صراعً مريرٌ طويلٌ إبتدأ من الصف الرابع وحتى الصف الثالث المتوسط ، وظل يوسف محافظاً على المرتبة الآولى وعلي يطارده محافظاً على المرتبة الثانية ، ولم يتفوق علي على يوسف في أي صف. فشاب علاقتهما الفتور والغيرة لكنهما كانا يتبادلان الإحترام ولا يسيء أي منهما للآخر ، وأصبحت العلاقة بينهما رسمية تقتصر على السلام والتحيات والكلام الرسمي بعيدة عن الإلفة وخلت من المحبة أحيانا وخاصة قبل إعلان النتائج بأيام. كان يوسف منتمياً لشلة من الطلبة وكان أكثر انخراطاً في جو المدرسة واللعب مع الأقران، وعلي ظل محافظاً على العزلة والخصوصية . وبعد انتهائهما من المرحلة المتوسطة دخلا إمتحان الوزارة للمرحلة الإعدادية حيث كان يعقد على زمانهما ، وكان يوسف من العشرة الأوائل ولم يكن علي من بينهم.
وفي العام الدراسي 1966-1967افترقا في الصف الأول ثانوي في مدرسة ثانوية متخصصة في المدينة وكانت تجمع طلاب القرى التابعة إدارياً للمدينة ، ونجحا بامتياز وظل يوسف محافظاً على المرتبة الآولى وعلي تراجع للمرتبة الثالثة فقد توفي والده في ذلك العام وتخلى عنه إخوته ولم يتحملوا مصاريفه وصارت أمه تعاني من ضرتها وأولاد ضرتها الذين أمسكوا بزمام الأمور بعد وفاة والدهم وتحكموا بمصير العائلة وبالميراث. فخافت أمه عليه فأرسلته الى خالته في عمان نازحاً ليكمل دراسته عند خالته في عمان. أما يوسف فقد اضطرته ظروفه الخارجة للتواجد في عمان نازحاً بعد الحرب. وشاءت الأقدار والظروف أن يتجاورا في عمان. ودخلا الصف الثاني الثانوي فاختار يوسف الفرع العلمي واختار علي الفرع الأدبي وكان الإفتراق هنا حتمياً. وظلت العلاقة تتراوح في إطارها الرسمي غير الحميمي.
كانت ظروف خالة علي المادية والمعيشية صعبة وأصبحت بعد الحرب أكثر صعوبة ، فلم تستطع توفير مصاريف ابن اختها الدراسية ، وبدأ علي يشعر بالقهر والحرمان وعزة النفس ويخشى ويخجل ويتحرج أن يطلب من خالته مصاريف الدراسة ، فضاق به الحال ولم يتعرف عليه أخوته ، واسودت الدنيا في وجهه ،وكان متمسكاً بدراسته ولا يريد التضحية بها في أوان قطافها ونضوجها ، وأخيراً قرر أن يسرق ليكمل دراسته ، وفعلاً غررت به نفسه وأخذ يسرق من البيوت ، وفي أحد الأيام سرق من أحد البيوت المجاورة قطعاً من الذهب وباعها في سوق الذهب ، وحامت حوله الشبهات ، وتم توجيه الإتهام له من صاحب البيت ، واستدعيت الشرطة وحققت بالموضوع ووصلت الى السارق حيث تعرف عليه الصائغ الذي اشترى منه الذهب، إنه علي ، ورأى يوسف من بيته المجاور الشرطة والناس مجتمعين ، وذهب يستطلع الموضوع فإذا بصاحبه اللدود القديم علي مخفوراً وم/*/*/*شاً والشرطي يضربه ويسوقه للسجن ، فحزن يوسف عليه حزناً شديداً وجاداً من الأعماق ، وكان علي في ذلك الوقت يعتبر حدثاً لا تنطبق عليه العقوبات بالسجن ، فأودع دار الأحداث وضاعت عليه السنة الدراسية ، وفي دار الأحداث تولاه مصلح اجتماعي ورعاه واكتشف ذكاءه فطلب منه بعد مضي سنتين ضائعتين أن يقدم الثانوية العامة -دراسة خاصة ، فقبل الفكرة ودرس في مركز الأحداث دراسة خاصة بالفرع الأدبي ، وقدم امتحان الثانوية العامة سنة 1971 وكان من العشرة الأوائل على المملكة. فحصل على بعثة دراسية لدراسة الأدب الإنجليزي. وتخرج من الجامعة بامتياز أهله ليعين معيداً فيها ويكمل الماجستير ثم الدكتوراة ، وهو اليوم استاذ كبير في الجامعة التي تخرج منها يناقش رسائل الماجستير والدكتوراة ويعتبر من أعمدة الجامعة ويشار اليه بالبنان.
أما يوسف فقد أكمل الصف الثاني ثانوي بنجاح دون المتوقع ، ولم يعد لديه الجدية في الدراسة وكان يؤجل الدراسة لمرحلة التوجيهي ، فمن المتعارف عليه بين الطلاب أن مرحلة الثاني ثانوي تعتبر محطة استراحة للطلبة لالتقاط الأنفاس قبل البدء في مرحلة تقرير المصير ، كما أنه انشغل بالعمل الفدائي والتنظيمات الحزبية ، وفي سنة الثانوية العامة عام 1969استأجر غرفة بالسطح مع زميل له في بيت تسكنه عائلة مكونة من أم وابنتيها ووالد زوجها العجوز وكان قد مات رب الأسرة ، وكانت البنتان تدرسان ، الكبرى بالصف الثاني ثانوي والصغرى بالثالث الإعدادي. وكانت العائلة منفتحة ومتحررة ومن غير ديانته (من قوم عيسى) ، فدخل يوسف في علاقة غرامية مع البنت الكبرى ، وكانت الأم تطلبه لتدريس ابنتيها لمادتي الرياضيات والعلوم. وكان يوسف يقضي معظم وقته في بيت العائلة بحجة تدريس البنات، وأصبح واحداً منهم ، وكان يمارس غرامياته مع عشيقته بأريحية ويسر، فنسي الدراسة وركن الكتب جانباً ، وبدأت الأيام تمر مر السحاب وهو منهمك في الغرام والحب والعمل الحزبي والفدائي ، وكان يذهب للمدرسة مستمعاً ، وبعد العودة من المدرسة يقضي وقته متلهياً مع العائلة ، وكانت عشيقته تزوره بغرفته في غياب أمها وبعد نومها متسللة ، ويتطارحان الغرام في جنح الليل وفي وضح النهار ، اقترب موعد الإمتحان ولم يتبق عليه الاّ اسبوعين ، واستيقظ يوسف من غيبوبته الدراسية ، وصحا على نفسه غريقاً في بحر هائج تتقاذفه فيه الأمواج وتشده للقاع نحو الغرق ، وكان أهله وأقاربه ومعارفه ينتظرون منه التفوق في التوجيهي كعادته سيما وقد استأجر بيتاً مستقلاً ليتفرغ للدراسة ويقابل التحديات ويلاقي الطموحات ، وأن يكون من العشرة الأوائل كما عودهم ورفع رؤوسهم في مترك الإعدادي. وفجأة قرر أن يحسم الأمور ويرحل من البيت ليتفرغ للدراسة في الأسبوعين الأخيرين فلم يكن قادراً على المقاومة وكبح مشاعره وغرائزه المتدفقة ، كيف لا وهو القادم من القرية ومن أغوار الحرمان وهو المتعطش للرومانسية والحب. فانجرف في هذا التيار منقاداً بمقود عواطفه وغرائزه ، سابحاً تارة ومتخبطاً تارة أخرى يهدده الغرق والإستقرار بالقاع .
ليته لم يقرر الرحيل ، فقد كان حبه لها جاداً وعميقاً وبكل الحواس والمشاعر ، فبعد الرحيل أصيب بصدمة عاطفية لم يقو على مقاومتها فأخذ يعاني من لواعج الفرقة ، وآلام البعد عن الحبيبة ، فزاده البعد عنها بعداً عن الواقع الذي أيقظه من غيبوبته ، وزاده قرباً من الخيال والسراب والهيمان وعانى من الحرمان من الوصال بعد اتصال كان ميسراً وسهل المنال ، يحوم حول بيتها ولا يستطيع التواصل معها برفض من داخله تنفيذاً لقرار صعب اتخذه ولا رجعة فيه، فلم يعد يذق للنوم طعماَ ، وارتبك في دراسة المواد ومراجعتها ، فأخذ يتصفح الكتب المقررة وكأنه حديث العهد بها ، يمر عليها مرور الكرام ويتذكر ما سمعه من الشرح وعقله مشدود للخلف وفكره مشغول بالحبيبة الضائعة وذكرياته معها، وراجع بسرعة بعض المواد الهامة وسط الذهول من انقطاع حبل الوصال مع الحبيبة المستحيلة باختلاف الديانة، ومن مفاجأة الإمتحان مثله كساعٍ الى الهيجا بدون سلاح. وكان يلهج بدراسته ويسابق الزمن من أجل النجاح ، أدرك أنه لن يحقق طموحه وطموح أهله ، فهبط سقف توقعاته من أن يحصل على معدلٍ يوازي إمكاناته العقلية والذهنية ، وأيقن أنه أهدر وقته وطاقاته وأسلحته لخوض المعركة ، وأخذت الأفكار تتصارع في عقله ، تارة يفكر بالإستمرار ، وتارة أخرى بالإنسحاب ، وأصبحت مشكلته هي تبرير النتائج في كلا الحالتين ، أصبح يعاني من قلة النوم وانعدام الشهية للأكل والرغبة في الإنسحاب من الحياة ، ومن زحمة الأفكار وتصارعها ، ومن محاسبة النفس واللوم على التقصير ، وخوفه من مواجهة طموحات أهله وآمالهم فيه ، ومن الشوق واللواعج للقاء الحبيبة ، ويبدو أنه كان الإنهيار في الثقة بالنفس تجاه الإمتحانات والإنهيار العصبي ، وأخيراً دنا موعد الإمتحان ، وتحت وطأة الضغوط عليه من كل الجوانب والإتجاهات برَّر لأهله بأنه يعاني من مرض عضوي في معدته لا يمكنه من الدراسة ولا يستطيع الأكل ، وأخذه أهله للطبيب فوصف له دواءً للمعدة ، ولكنه يدرك كنه ما ألم به ، فأبدي وتظاهر بعدم استجابته للعلاج ، فأخذوه الى طبيب آخر ، وأصبح يتردد على عيادات الأطباء ، وأخبر أهله بأنه سينسحب من الإمتحان ولن يذهب لتقديم الإمتحانات وسيعيد التوجيهي في السنة المقبلة ، ولكنهم طلبوا منه الإستمرار وأخبروه بأنهم سيقبلون بأي نتيجة كانت ، وتولد لأهله شعورٌ وتيقنوا بأنها عين الحسود التي أصابته ، وأوصلوا له الفكرة ، وقد ولدت في نفسه راحة وأوجدت له تبريراً لما يحصل معه ، وطلبوا منه أن يذهب معهم للشيوخ والفتاحات للقراءة عليه ، فسايرهم وهو بداخله يرفض هذه الأفكار ويعلم جيداً ما أصابه. وكان والداه يسهران عليه الليالي الطوال قبل وخلال الإمتحانات وهو يتظاهر أمامهما بالآلام العضوية الحادة في بطنه ، وفي صبيحة أول يوم ذهب للإمتحان منهك الجسم ، متثاقلاً في مشيته وهزيلاً ونحيفاً ومحبطاً ويائساً ومشوشاً في بصيرته ، وأمضى فترة الإمتحان بهواجس الرسوب ، فكلما أكمل مادة واطمأن على نجاحه بها من واقع الإجابات ، يبدأ التفكير في المادة المقبلة ، وينتابه شعورٌ يتحول الى يقين بالرسوب في تلك المادة ، فينهشه شبح المادة بالخوف ويصيبه الأرق والقلق ، ولم تكن ذاكرته القوية تسعفه بمخزونها الضئيل عن تلك المادة لقلة الدراسة والمتابعة ، فيتصور أنه لا يحفظ أو يتذكر منها شيئاً. ويدخل الإمتحان ويؤديه في ساعة أو أقل يُفرِّغ ما لديه من معلومات ويخرج ، لا يراجع ولا ينتظر لعله يتذكر شيئاً يضيفه ، فقد قرر في نفسه أنه سيرسب وسيعيد التوجيهي. وانتهت الإمتحانات وأخذ ينتظر النتيجة ويتمنى الرسوب لإعادة الإمتحان في السنة المقبلة مستفيداً من تجربته المتعثرة ، وكان يوم إعلان النتائج ، وجلس أهله بجانب الراديو يستمعون للنتائج ، وقد ضربوا كفاً بكف عندما لم يسمعوا اسمه من العشرة الأوائل وفي قرارة أنفسهم أنه لولا العين والحسد لكان من ضمنهم. وأخيراً سمعوا اسمه من الناجحين ، فانطلقت البنادق تطلق الرصاص في الهواء فرحة بنجاح جاء من هبة السماء ، ولكنه لم يفرح لتوقعه الحصول على معدل دون المستوى المطلوب لدخول الكلية التي ينشدها وهي كلية الطب كخيار أول أو الهندسة كخيارٍ ثانٍ ليحقق طموح وتمنيات أهله المتعطشين لذلك والمنتظرين له بفارغ الصبر. وخلال انتظار النتائج أخذ يستعيد عافيته العاطفية والذهنية بعد مراجعة جادة مع النفس.
في اليوم التالي ذهب يوسف للمدرسة لإحضار كشف العلامات ، لقد فوجيء بالمعدل ، لقد حصل على معدل 86% ، فقد حصل على علامة شبه كاملة بالرياضيات ، وعلامة عالية نسبياً في المواد العلمية (فيزياء وكيمياء( وعلامة متوسطة في الأحياء وعلامة شبه كاملة في اللغة الإنجليزية ، ومما خفض من معدله حصوله على علامات متدنية ومتوسطة في مواد الحفظ والمواد الأدبية، وكانت ظروف أهله المادية لا تسمح بدراسته في الخارج على حسابهم ، ولم يكن بالجامعة الأردنية كليةً للطب أو الهندسة ، فسجل في كلية العلوم ، وحصل على معدل عالٍ في السنة الآولى يتناسب مع قدراته بعد أن تخلص من ذكريات الماضي، وانكب على الدراسة ليعوض ما فاته وأهّله معدله في الجامعة ليحول من كلية العلوم الى كلية الطب التي افتتحت في ذلك العام ، وانتظم بكلية الطب جاداً ومهتماً بدراسته مستفيداً من أخطاء الماضي وانزلاقاته الخطرة ، وكان يحصل على قروض من صندوق إقراض الطلبة كل عام ، وتقشف في مصاريفه ليهوِّن على أهله ولم يكلفهم شيئاً ، وتخرج وكان الأول على الدفعة ، فقدم أوراقه لجامعة أمريكية بتوصية من دكتور أمريكي كان معاراً من تلك الجامعة للجامعة الأردنية وكان مشرفاً على بحث التخرج الذي أعدّه يوسف ، فالتقطوه فوراً وهيئوا له وسائل البحث ، وأعطوه سكناً فاخراً ودخلاً عالياً ، وهو الآن من اطباء جراحة القلب المشهورين هناك. وفكر بالعودة للجامعة الأردنية ودفعوا له راتباً شهرياً لا يساوي دخله في نصف يوم واحد في أمريكا. وقرر البقاء هناك وحصل على الجنسية الأمريكية ويعيش عيشة الأثرياء ويعمل بالبحث في االعلوم الطبية والدوائية ويمارس هوايته بالأدب والثقافة.
لم يلتق الصديقان اللدودان منذ أن افترقا عام 1971 ، ومضى الدهر متسارعاً يغير بشكليهما ومظهريهما ، الى أن جاء يوم في منتصف عام 2006م ، كلفت الجامعة الأستاذ الدكتور علي بالسفر الى الولايات المتحدة لتمثيلها في مؤتمر عقد هناك ، واستقل الطائرة من بيروت متوجهاً الى أمريكا عبر جنيف ، وفي مطار جنيف نزل بعض الركاب وصعد آخرون ، وكان من الصاعدين الطبيب الأستاذ الدكتور يوسف ، وجلس يوسف بجانب علي ، وقد تهيأ لكل منهما أنه يعرف الآخر ، فقد التبس عليهما الأمر وراودهما الشك ، وعاد يوسف بذاكرته القوية للوراء يستعرض شريط حياته ، ويبدو أن الشك لديه تحول الى شبه يقين بأنه يجلس بجانب صديقه اللدود ، فطلب من جاره في المقعد أن يتعارفا لتأكيد ظنه الذي تيقن منه ، وكانت المفاجأة السعيدة لكليهما ، وقاما وتعانقا طويلاً ، وأمضيا الرحلة في استعراض لماضيهما وذكرياتهما ، واتفقا على التواصل بكل الوسائل. وعادا صديقين حميمين يتواصلان باستمرار وبما يتاح لهما من فرص اللقاء.
بقلم أحمد ابراهيم الحاج
25/10/2008
.......................
في المراحل الدراسية الآولى(الصف الأول والثاني والثالث الإبتدائي( وفي أحيانٍ كثيرة ربما قلّت مع تقدّم الزمن ولكنها ما زالت قائمة ، يصعب على المدرسين اكتشاف الطلبة الأذكياء المتفوقين وفرزهم وتمييزهم عن الطلبة العاديين ، لذلك فإنه من الصعوبة بمكان أحياناً معرفة مستويات الذكاء الحقيقية للأطفال وتصنيف الطلبة على هذا الأساس، ومن الخطأ إطلاق الأحكام عليهم ووصمهم بصفات هذه الأحكام السابقة لأوانها من صغرهم لتكبر معهم وتحد من إنطلاقتهم وقدراتهم ، انطلاقاُ من المثل الشعبي القائل (الديك الفصيح من البيضة بصيح(، ويبرز ويظهر في تلك الصفوف الإبتدائية الآولى الطلبة الذين يتميزون بالجرأة والشجاعة وطلاقة اللسان وسرعة البديهة ومن يجيدون التمثيل وسرد الحكايات ، والنفاق الموجب (حيث أنهم ببراءتهم لا يعرفون بعد النفاق السالب)، وكذلك أصحاب النكتة والتهريج وهواة التمثيل والفن من ذوي المستويات المتوسطة من الذكاء ويتفوقون على الطلبة حادي الذكاء والذين يتميزون بالقلق والخوف والسرحان في ميادين خيالهم الواسع ، وعدم الجرأة والتسرع ، ويميلون للتحليل والإمعان قبل الكلام ، ويخشون المبادرة السريعة خوفاً من الوقوع بالخطأ والتعرض للعقاب ، ويتميزون بالذاكرة القوية والقدرة على التخزين والإستدعاء للمعلومات برويَّة ، وبحسن الإنصات والإستماع ، وبقلة الكلام والثرثرة والنزعة للعزلة في بعض الأحيان ، وإن نطقوا أو تكلموا أوجزوا وأوفوا بالمراد وكأنهم ينطقون حكما في كلام مختزل مركز كالأمثال الشعبية والحقائق العلمية والمعادلات الكيميائية الموزونة.
في الفاتح من (أيلول) عام 1957م دخل المدرسة للصف الأول الإبتدائي في إحدى قرى فلسطين طالبان من قريتين متجاورتين ومشتركتين في مدرسة واحدة ، هما (يوسف من قرية أ وعلي من قرية ب.( فما قصة هذين الطالبين اللذين أصبحا صديقين لدودين أثناء دراستهما معاً في فصل واحد من الصف الأول الإبتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي ، وها هما الآن قد افترقا وصارا من المتفوقين والمبدعين في علمهما وعملهما ونشاطاتهما الأدبية والثقافية.
بدأ يوسف حياته الدراسية بالنكد والبكاء والعناد لأهله ، لا يريد الذهاب للمدرسة ، إنه القلق والخوف من المجهول ، ففي هذا اليوم بدأ والده رحلة الى سوق الحلال بالمدينة مبكراً لبيع الخراف والجديان ، وكان أهله يقدمون له الحوافز ويستدرجونه للقبول خفية عن أخيه الأكبر لكي لا يسمعه فيضربه ضرباً شديداً لا يرحم ، فقد كان أخوه الأكبر الساعد الأيمن لوالده في توفير الرزق للعائلة ، وكان هو الحاكم للأسرة في غياب الأب ، وكان متسلطاً خالياً قلبه من الرحمة والعطف ، يضرب أخوته وأخواته بذنب وبدون ذنب ، وكان صاحب السطوة والقوة الجبارة التي لا تقاوم ولا يُعصى لها أمر.
في أول يوم دراسي أفاقت الأم يوسف من نومه ، فتظاهر بالمرض وبألم في رجليه لا يستطيع المشي ، فطلب يوسف منهم أن يوصلوه راكباً على الحمار مؤملاً أن لا يوافقوه ويستسلموا لرغبته في عدم الذهاب ، كما طلب منهم قرشين ليشتري أسكمو وحلقوم وحامظ حلو، وكان القرش في ذلك الزمان يعتبر مبلغاً باهظاً لمصروف طالب ، فشد أخوه الذي يكبره مباشرة بست سنوات البردعة على ظهر الحمار ، وأعطته أمه قرشاً واحداً ووعدته بالقرش الثاني عندما يبيض الدجاج، (حيث كانت العشر بيضات تُباع بعشرة قروش وقرش بحساب عجوزٍ كانت تبيع وتشتري البيض وترفض شراء العشرة بيضات بأحد عشر قرشاً، وتصر على أن العشرة ببريزة بيضاء وقرش أحمر)، واركبوه على الحمار خفيةً عن أخيه الأكبر ، وسار به أخوه حتى أوصله المدرسة ، ولما أنزله عن ظهر الحمار وأدار اتجاه الحمار يريد العودة للبيت ، أبى يوسف الدخول للمدرسة وأخذ يصيح باكياً ، فربط أخوه الحمار خارج سور المدرسة (حيث كان السور عبارة عن سنسلة حجارة( وأدخله محمولاً بين يديه ، وهو يرفس ويلوح بيديه يميناً ويساراً وبرجليْه للأعلى وللأسفل ، ويدفع أخاه بيديه ويخرمشه بأظافره ، ويرفض التقدم نحو جموع الطلبة ، فتناوله أحد المدرسين ممسكاً بيده بلطف مصطنع ، وقال لأخيه إرجع أنت وسنتولى نحن أمره ، وهنا ازداد صياحه وعلا صوته وانتفخت أوداجه ، فأمسكه المدرس من أذنه فشد عليها بين أصابعه وقرصها ، ولما اختفى أخوه عن الأنظار عائداً للبيت ، صفعه المدرس على خده وضربه بالعصاة على جنبيه ، وصاح به صوتاً أخافه وجمده مكانه ، فامتثل لأمر المدرس، ومشى معه مكرهاً تحت ضغط الخوف والرهبة ، ولكنه كان بنتفض من الداخل ويكبت في صدره بركاناً من الرفض والخوف والقلق والثورة ، ويحشر صياحه في حنجرته المنتفخة مانعاً له من الخروج ، وكانت دموعه الحارة تسحل على خديه كسح المطر في غياب العواصف وسكون الهواء ، وكان أنفه يسيل سعالاً ، فامتزجت دموعه مع سعاله ، وابتلت أرجل بنطاله من شدة الخوف ، وأخذ يمسح بيده عن خديه ليزيل هذا المزيج الذي يعبر عن الخوف والرهبة ، وبعد ذلك يمسح يديه المبتلتين في بدلته الكاكي الفضفاضة لكي تخدمه لأكثر من سنة (ثلاث سنوات على الأقل( ، ويمسح بيده الأخرى في شنطته التي خاطتها له أمه من كيس الطحين الفارغ من ماركة ممتاز، والذي كتب عليه (تقدمة من الشعب الأمريكي).
قرع الجرس واصطف الطلبة القدامى في طوابير ، وجمع المدرسون الطلبة الجدد في ساحة في جانب الملعب القريب من بناء المدرسة ، وكان عددهم آنذاك يتجاوز الأربعين طالباً من القريتين ، ولكن مبنى المدرسة والمباني المستأجرة لا تسمح بتوزيعهم على فصلين ، فوضعوهم في فصل واحد ، وكانت المقاعد الدراسية طويلة والفصول واسعة ، فكل مقعد يتسع لستة طلاب وأحياناً لأكثر من ستة طلاب ، كان حوالي عشرة تلاميذ من الأربعين يبكون ولا يريدون الإنخراط في هذا الوضع الجديد الذي فصلهم عن أمهاتهم وآبائهم وحد من حريتهم في اللعب والكلام والحركة وسط جو من الرعب ، حيث شاهدوا المدرسين يحملون العصي للتلاميذ وشاهدوا بأعينهم في اليوم الأول كيف يضرب المدرسون التلاميذ القدامى من الذين لا يلبسون بدلة الكاكي، والذين تأخروا عن الطابور، ومن كانت أظافرهم وشعورهم طويلة ، وقد تسامح المدرسون في اليوم الاول مع الطلبة الجدد استثناءً ، فكانت شعور بعضهم وأظافرهم طويلة وقسم كبير منهم لا يلبس بدلة الكاكي للفاقة والفقر ولزحمة العمل عند الخياط الوحيد بالقريتين.
دخل طلاب الصف الأول الى الفصل وأصوات البكبكة تنطلق من العشرة المخلفين في آخر الطابور ، وتم توزيعهم على المقاعد حسب الطول والواسطة ، أما الطلبة الذين كانوا يبكون فقد أُجلسوا جميعهم في المقعد الأخيرعقاباً لهم ، ودخل المدير الى الفصل عاقد الحاجبين مكشراً ومكفهر الوجه ، وألقى بتعليماته ونذره بالعقاب للطلبة الجدد وهو يلوح بعصاه غير الملساء وغير المهذبة حيث تظهر عقدها ونتوءاتها للطلبة كإنذار بشدة العقاب.
وقال المدير : اليوم سماح يا أولاد ، وغداً سوف نطبق عليكم قوانين المدرسة كمن سبقوكم اليها وكما رأيتم بأعينكم اليوم ، اسمعوني جيداً وطرق بعصاه على طاولة الأستاذ ، من يأتي وشعره طويل فسوف يكون عقابة عشرة عصي بهذه العصا ، ومن كانت أظافره طويلة فسوف يُضرب خمسة عصي على ظهر يد واحدة ، ومن يأتي ولم يلبس بدلة الكاكي فجزاؤه فلقة على رجليه أمام الطلبة في الطابور. وكان العشرة المخلفين الرافضين الأواخر ينتفضون خوفاً ورهبة ، وكان يوسف يجلس بجوار علي في المقعد الأخير ، فعلي أحضره أبوه للمدرسة ، ولكن من هو علي؟
كان أباه متزوجاً من اثنتين ، الزوجة القديمة أم أولاده الكبار الذين لم يدخلوا المدرسة ، والزوجة المعزوزة الجديدة أم علي والتي لم تُنجب غيره بعد وقت طويل من زواجها كادت فيه أن تفقد الأمل بالخِلفة ، فكان وحيد أمه ومدللاً من أبويه، وبالأخص من أمه ، فوجد صعوبة في فراقها والذهاب للمدرسة وكان حاله كحال يوسف في رفضه وعناده وبكائه وصراخه ، ولكن لم تُفرك أذنيه ولم يُصفع على خده ويُضرب بالعصا لوجود والده معه بناءً على توجيهات والدته صاحبة الصول والجول والكلمة ، وخلال وجود الطلبة بالفصل شعر علي بحاجته للعراء ، ولم يكن بالمدرسة دورة مياه حيث كان الطلبة يخرجون في الفسح بين الحصص لعراء قريب من المدرسة ويصطفون خلف سنسلة الكرم المجاور للمدرسة ويقضون حاجاتهم الخفيفة، أما الحاجة الثقيلة فكانت تتطلب عملاً شاقاً لتأديتها وتضع صاحبها في حرج كبير حيث يتطلب الأمر اعتلاءه للسنسلة وقضاء حاجته خلفها بعيداً عن الأنظار. في بداية شعور علي بالجاجة للعراء خاف من أن يطلب الإذن من الأستاذ للخروج لقضاء الحاجة ، واخيراً اضطر لطلب ذلك فرفع اصبعه بخجل وطلب بصوتٍ متهدج وهو يعصر جسمه، فصاح به الأستاذ يأنبه ويزجره ويطلب منه الإنتظار للفسحة ، فاستسلم للأمر وبلَّل بنطاله كجاره يوسف، ولمّا خرجا من الفصل تجمع حولهما الطلبة يسخرون منهم ويقهقهون على عملتهم السوداء ، وكان والد علي في الستين من عمره آنذاك وكانت أمه في الأربعين ، وكان إخوته غير الأشقاء ينبذونه ويكرهونه كإخوة سيدنا يوسف عليه السلام ، لأنهم كانوا يشعرون بتمييز والدهم وانحيازه لإبن ضُرَّة أمهم. لذلك لم يشعر علي بمشاعر الأخوة والإلفة والترابط الأخوي والأسري في البيت ، لقد كان معزولاً من إخوته لا يشركونه باللعب معهم بالرغم من وجود من يقاربه بالسن بينهم ، وكان فاقداً للأمن والأمان ، ويشعر بالإضطهاد من إخوته الكبار ، فكلما سنحت لهم فرصة الإنفراد به كانوا يحقرونه وأحياناً يضربونه . وكان يشتكي لأمه فتحرض أباه على أبنائه الآخرين فيضربهم وبالتالي يزيد حقدهم عليه وحبهم للإنتقام منه، وهكذا كانوا يعيشون في دوامة من العنف والعنف المضاد ودائرة من الفعل وردة الفعل ، لذلك كان جو المدرسة رهيباً ومخيفاً له لانعدام الأمن الإجتماعي والأمان في البيت، وكان يفتقد للأمن الأسري المتكامل المترابط ويعاني من نقصٍ في مشاعر الأخوة بعكس الفطرة البشرية ، كان يتمنى أن تلد له أمه أخاً أو أختاً ليكون كباقي الأولاد ، وليشكلوا له خيمة تحميه وتظلله وتدافع عنه عندما يخرج خارج البيت ، فكان يتعرض للضرب والإضطهاد من أطفال الحارة ولا يرى من يدافع عنه من إخوته بالرغم من استنجاده بهم ووقوفهم متفرجين عليه وهو يُضرب ويُهان ويُضطهد. فقد استوطى الأطفال حائطه وكانوا يفرغون بطولاتهم المزعومة وشقائهم به ، مما اضطر والدته أن تمنعه من الخروج الى الحارة للعب مع الأطفال ، فحرم من الطفولة ولهوها، فتولدت لديه عقدة العزلة وتعود عليها وصارت سمةً من سماته مما جعله يشعر بالخوف إن خرج بعيداً عن والدته التي كانت تخاف عليه من نسمة الهواء لشعورها بأنه سيكون سندها في المستقبل سيما وأن زوجها الذي يكبرها بعشرين عاماً يقترب من نهاية العمر وهي ما تزال صغيرة.
ونعود الى التعريف أكثر بالبطل الآخر للقصة، أما يوسف فقد كان ترتيبه العاشر بين إخوته وأخواته الخمسة عشر ، والذين مات منهم خمسة بالحصبة وبقي عشرة على قيد الحياة لم ينل الكبار منهم فرصة التعليم ، فقد جاء يوسف للحياة في وقت ملَّ فيه الوالدان من الخلفة والخلف ، فقد كانت الأم تلد في كل عام ، وقد مات قبله مباشرة من الإخوة إثنان وبعده مباشرة من الإخوة إثنان ، لذلك كان العائلة تتشاءم منه ومن فاله السيء ، وكانوا يلقبونه أبو سعد )الغراب( وأحياناً كانوا ينادونه يا "غراب البين." وقد دهمته الحصبة في صغره مع اثنين من إخوانه وكان هو أوسطهم سناً ، وكان أضعفهم بنياناً وأكثرهم اعتلالاً ونالت منه الحصبة كثيراً ، وكانت الأسرة تتوقع أن تأخذه الحصبة بجرائرها كعادتها في كل عام ، وينجو منها أخواه ، ولكن ما حدث هو أن مات اخواه وبقي هو النحيل المنهك على قيد الحياة ، كان نحيلاً ضعيف البنية أصفر اللون وكان مهملاً ويعاني من سوء التغذية وقلة الرعاية. لم يكن يوسف كغيره من الأطفال يشعر بحنان الأب الذي كان منهمكاً بتدبير لقمة العيش لهذه العائلة الكبيرة وكان يعمل بتجارة المواشي ويرتاد سوق الحلال بالمدينة مشياً على الأقدام أو ركوباً على الحمير ، فكان يغيب كثيراً عن البيت والأسرة ، ولم تكن أمه ترويه بالحنان لإنشغالها بتدبير الطعام والقوامة في غياب الزوج ولكثرة همومها ومهامها ، وانشغالها في موسم الحصاد والدرس وجمع الزبل للطابون ونقل المياه على رأسها للشرب والعجين والخبيز والطبيخ والنفيخ، وحلب البقر والأغنام وتحضير اللبن والزبدة والجبن ، وتربية الطيور من دجاج وحمام ، ولكثرة أبنائها وتتابعهم الموسمي السريع دون أن يأخذ الطفل حقه من الرعاية والحنان ، وكانت تقاسم زوجها بل تزيد عنه في بذل الجهد والعرق والكد والتعب من أجل توفير قوت الحياة لأولادهم ، وكذلك كان إخوته الكبار والذين حُرِموا من التعليم يشرفون على الأرض ويقومون بأعمال الفلاحة بحرث الأرض وزراعتها ، والحصاد والدرس ورعي البقر والغنم ، فكانت كل هذه الجهود لم تكن قادرة على توفير بحبوحة من العيش نظراً لسوء الأوضاع الإقتصادية والسياسية في ذلك الوقت. فتربى يوسف مهملاً مهمشاً لا يأبه به أحد ، منعزلاً وفاقداً للحنان والأمن الأسري ، كان يعمل مع العائلة في رعي الغنم والبقر وفي نقل الحصاد الى البيد\ر (الجرون( ورعاية المقاثي والكروم ، وفي الدرس والتخزين ، يفيقونه من النوم مبكراً أيام الحصاد صيفاً ، وأيام البرد شتاءً لرعاية الأغنام بحذاءٍ مخيط ورقيق (كوشوكة)، وكان الحذاء مثقوباً ويضع في الثقب كرتونة، ويلبس لباساً لا يقيه البرد ويحمل كسرة من الخبز يغمسها بالحليب من النعاج أو الماعزوهو سارح يرعى الغنم ، وكان حينها لم يبلغ السادسة من عمره بعد. لذلك شعر يوسف بالرهبة والخوف من جو المدرسة الضيق والمحصور والمحتشد بالتلاميذ على مختلف الأنماط، ومن تحذير ونذر المدير والمدرسين ومن الطلاب ممن يكبرونه سناً.
جمعتهما (يوسف وعلي( عوامل وقواسم مشتركة في المدرسة وفي الأيام الآولى منها بالتحديد ، إنها عوامل الرهبة والخوف والبكاء والرفض ، فشعر كل منهما بمقاسمته للآخر في مشاعره ، وأدى ذلك الى إلفة وشعور بالتقارب ونوع من الأمن المشترك على الرغم من اختلاف اهتماماتهما وميولهما، فكان كل واحد منهما يمثل عزاءً للآخر ، وربط بينهما خيطاً واهناً ورفيعاً من الصداقة والتقارب على قاعدة واهنة من الصفات والميول، حيث جمعتهما صفات خوفٍ وضعفٍ لا تشرِّف صاحبها ، ومن منطلق المصلحة المتبادلة استلطف كل منهما الآخر، وكان بيتاهما متقاربين ، فصارا يذهبان للمدرسة ويعودان منها معاً ، يخرج يوسف الى بيت علي ثم ينضم اليه علي في ذهابهما وإيابهما من المدرسة. وكان يجمعهما نظرة المدرسين المتشابهة لهما ، فقد نُظِر اليهما أنهما الطالبين الكسولين واللذين لا يشاركا بالفصل ، هذا علاوة عن اضطهاد الطلبة لهما من تعليقات المدرسين عليهما ووصفهما بالغباء والبلادة والضعف والخوف.
اتفقا ذات يوم على خداع أهلهما وعدم الذهاب للمدرسة خوفاً من المدرسين وتعليقاتهم ومن الطلبة واستهزائهم خلال الفسح ، فقضيا اليوم في كرم قريب من المدرسة ولما عاد التلاميذ لبيوتهم عادا الى بيتهما وكأنهما داوما كغيرهم من الطلاب. وتكرر الغياب الى أن جاء في ذات يومٍ صاحب الكرم ليتفقد كرمه ، ووجدهما يعبثان بالثمار والزرع ، فاشتكى لأهلهما وانكشف أمرهما ، ونالا عقاباً من اهلهما ومن المدرسة . فكانت نتائجهما في السنة الآولى متقاربة جداً ، يوسف احتل الترتيب الخامس والثلاثين على الفصل وعلي السادس والثلاثين من أربعين. ولمّا لم يجدا منفذاً لترك الدراسة بدءا يتأقلمان تدريجياً على الجو الجديد ، وفي السنة الثانية تحسنت نتائجهما فأحرز يوسف الترتيب السابع عشر وعلي الترتيب العشرين ، وبدأ المدرسون يكتشفون قدراتهما الدراسية المخبأة وغير المستثمرة تدريجياً ، وفي السنة الثالثة نال يوسف الترتيب الخامس وعلي الترتيب السادس على الفصل. وبدأ التلميذان يتحرران من قيود الخوف والرهبة تدريجياً مع مرور الزمن، وبدأ المدرسون يكتشفون المزيد من قدراتهم العقلية والذهنية، ويطرون عليهما بحل المسائل الصعبة في الرياضيات وسرعة حفظ النشيد والمحفوظات وسور القرآن الكريم. وفي السنة الرابعة )الرابع الإبتدائي( قفز يوسف للمرتبة الآولى وعلي للمرتبة الثانية. ودخلت علاقتهما طوراً جديداً ومختلفاً ، إنه التنافس الحاد والمطاردة لنيل المرتبة الآولى. فقد كان الحكم في السنوات الثلاث الآولى على التقييم الشفوي للطلبة والجرأة في رفع الإصبع للإجابة، ولمّا بدأ التقييم التحريري بالإمتحانات ظهرت قدراتهما الذهنية والعقلية على ورق الإمتحان بعد أن تحررا من الضغوط ، وتفاجأ المدرسون بمستواهما التحصيلي والعلمي ، وكأنهما كانا مخبئين في قشورهما. قشور الخوف والرهبة التي غلفت لبيْهما وعقليْهما وربطت لسانهما عن الإنطلاق لشدة حرصهما من الوقوع في الخطأ ثم العقاب ولشدة حرصهما على صحة ما ينطقون به.
كان يوسف يمتاز بالذاكرة القوية والذكاء الحاد ويتفوق على علي قليلاً بالمواد العلمية ، وكان علي يتفوق قليلاً بالمواد الأدبية ، وكل منهما كان مبدعاً في كلا الفرعين ، ولم يكن يوسف يجيد المناقشة والمشاركة في الفصل بعكس علي الذي كان يمتاز بالجلد وحب المطالعة ونهم القراءة والإنتباه للشرح ويتفوق على يوسف بالمشاركة بالفصل وبمواضيع الإنشاء . كان يوسف لا يحب المطالعة والدراسة ويؤجل كل شيء ليوم الإمتحان ويميل الى اللعب واللهو والشللية والعصابات الطلابية وعدم الإنتباه للشرح ، وظل علي محباً للعزلة والمطالعة خارج المنهاج ، فكان يقرأ القصص والروايات بنهم ، فقرأ قصص يوسف السباعي ونجيب محفوظ وعبد الحليم عبدالله كلها ، وكان يحضر الدروس ويتابع الشرح والمشاركة. أما يوسف فكان يعتمد في ثقافته على المنهاج والسمع ، وكانت له بدايات أدبية وشعرية واعدة في صغره نالت إعجاب المدرسين، فبدأ كتابة الشعر مبكراً معتمداً على الموهبة فقط ، لكنه لم ينمّ مفرداته ولغته العربية بالمطالعة والقراءة إنما بالإستماع وسعة الخيال والتأمل في الطبيعة وما يلتقطه من تعابير وجمل بالمنهاج . وبدأ بينهما صراعً مريرٌ طويلٌ إبتدأ من الصف الرابع وحتى الصف الثالث المتوسط ، وظل يوسف محافظاً على المرتبة الآولى وعلي يطارده محافظاً على المرتبة الثانية ، ولم يتفوق علي على يوسف في أي صف. فشاب علاقتهما الفتور والغيرة لكنهما كانا يتبادلان الإحترام ولا يسيء أي منهما للآخر ، وأصبحت العلاقة بينهما رسمية تقتصر على السلام والتحيات والكلام الرسمي بعيدة عن الإلفة وخلت من المحبة أحيانا وخاصة قبل إعلان النتائج بأيام. كان يوسف منتمياً لشلة من الطلبة وكان أكثر انخراطاً في جو المدرسة واللعب مع الأقران، وعلي ظل محافظاً على العزلة والخصوصية . وبعد انتهائهما من المرحلة المتوسطة دخلا إمتحان الوزارة للمرحلة الإعدادية حيث كان يعقد على زمانهما ، وكان يوسف من العشرة الأوائل ولم يكن علي من بينهم.
وفي العام الدراسي 1966-1967افترقا في الصف الأول ثانوي في مدرسة ثانوية متخصصة في المدينة وكانت تجمع طلاب القرى التابعة إدارياً للمدينة ، ونجحا بامتياز وظل يوسف محافظاً على المرتبة الآولى وعلي تراجع للمرتبة الثالثة فقد توفي والده في ذلك العام وتخلى عنه إخوته ولم يتحملوا مصاريفه وصارت أمه تعاني من ضرتها وأولاد ضرتها الذين أمسكوا بزمام الأمور بعد وفاة والدهم وتحكموا بمصير العائلة وبالميراث. فخافت أمه عليه فأرسلته الى خالته في عمان نازحاً ليكمل دراسته عند خالته في عمان. أما يوسف فقد اضطرته ظروفه الخارجة للتواجد في عمان نازحاً بعد الحرب. وشاءت الأقدار والظروف أن يتجاورا في عمان. ودخلا الصف الثاني الثانوي فاختار يوسف الفرع العلمي واختار علي الفرع الأدبي وكان الإفتراق هنا حتمياً. وظلت العلاقة تتراوح في إطارها الرسمي غير الحميمي.
كانت ظروف خالة علي المادية والمعيشية صعبة وأصبحت بعد الحرب أكثر صعوبة ، فلم تستطع توفير مصاريف ابن اختها الدراسية ، وبدأ علي يشعر بالقهر والحرمان وعزة النفس ويخشى ويخجل ويتحرج أن يطلب من خالته مصاريف الدراسة ، فضاق به الحال ولم يتعرف عليه أخوته ، واسودت الدنيا في وجهه ،وكان متمسكاً بدراسته ولا يريد التضحية بها في أوان قطافها ونضوجها ، وأخيراً قرر أن يسرق ليكمل دراسته ، وفعلاً غررت به نفسه وأخذ يسرق من البيوت ، وفي أحد الأيام سرق من أحد البيوت المجاورة قطعاً من الذهب وباعها في سوق الذهب ، وحامت حوله الشبهات ، وتم توجيه الإتهام له من صاحب البيت ، واستدعيت الشرطة وحققت بالموضوع ووصلت الى السارق حيث تعرف عليه الصائغ الذي اشترى منه الذهب، إنه علي ، ورأى يوسف من بيته المجاور الشرطة والناس مجتمعين ، وذهب يستطلع الموضوع فإذا بصاحبه اللدود القديم علي مخفوراً وم/*/*/*شاً والشرطي يضربه ويسوقه للسجن ، فحزن يوسف عليه حزناً شديداً وجاداً من الأعماق ، وكان علي في ذلك الوقت يعتبر حدثاً لا تنطبق عليه العقوبات بالسجن ، فأودع دار الأحداث وضاعت عليه السنة الدراسية ، وفي دار الأحداث تولاه مصلح اجتماعي ورعاه واكتشف ذكاءه فطلب منه بعد مضي سنتين ضائعتين أن يقدم الثانوية العامة -دراسة خاصة ، فقبل الفكرة ودرس في مركز الأحداث دراسة خاصة بالفرع الأدبي ، وقدم امتحان الثانوية العامة سنة 1971 وكان من العشرة الأوائل على المملكة. فحصل على بعثة دراسية لدراسة الأدب الإنجليزي. وتخرج من الجامعة بامتياز أهله ليعين معيداً فيها ويكمل الماجستير ثم الدكتوراة ، وهو اليوم استاذ كبير في الجامعة التي تخرج منها يناقش رسائل الماجستير والدكتوراة ويعتبر من أعمدة الجامعة ويشار اليه بالبنان.
أما يوسف فقد أكمل الصف الثاني ثانوي بنجاح دون المتوقع ، ولم يعد لديه الجدية في الدراسة وكان يؤجل الدراسة لمرحلة التوجيهي ، فمن المتعارف عليه بين الطلاب أن مرحلة الثاني ثانوي تعتبر محطة استراحة للطلبة لالتقاط الأنفاس قبل البدء في مرحلة تقرير المصير ، كما أنه انشغل بالعمل الفدائي والتنظيمات الحزبية ، وفي سنة الثانوية العامة عام 1969استأجر غرفة بالسطح مع زميل له في بيت تسكنه عائلة مكونة من أم وابنتيها ووالد زوجها العجوز وكان قد مات رب الأسرة ، وكانت البنتان تدرسان ، الكبرى بالصف الثاني ثانوي والصغرى بالثالث الإعدادي. وكانت العائلة منفتحة ومتحررة ومن غير ديانته (من قوم عيسى) ، فدخل يوسف في علاقة غرامية مع البنت الكبرى ، وكانت الأم تطلبه لتدريس ابنتيها لمادتي الرياضيات والعلوم. وكان يوسف يقضي معظم وقته في بيت العائلة بحجة تدريس البنات، وأصبح واحداً منهم ، وكان يمارس غرامياته مع عشيقته بأريحية ويسر، فنسي الدراسة وركن الكتب جانباً ، وبدأت الأيام تمر مر السحاب وهو منهمك في الغرام والحب والعمل الحزبي والفدائي ، وكان يذهب للمدرسة مستمعاً ، وبعد العودة من المدرسة يقضي وقته متلهياً مع العائلة ، وكانت عشيقته تزوره بغرفته في غياب أمها وبعد نومها متسللة ، ويتطارحان الغرام في جنح الليل وفي وضح النهار ، اقترب موعد الإمتحان ولم يتبق عليه الاّ اسبوعين ، واستيقظ يوسف من غيبوبته الدراسية ، وصحا على نفسه غريقاً في بحر هائج تتقاذفه فيه الأمواج وتشده للقاع نحو الغرق ، وكان أهله وأقاربه ومعارفه ينتظرون منه التفوق في التوجيهي كعادته سيما وقد استأجر بيتاً مستقلاً ليتفرغ للدراسة ويقابل التحديات ويلاقي الطموحات ، وأن يكون من العشرة الأوائل كما عودهم ورفع رؤوسهم في مترك الإعدادي. وفجأة قرر أن يحسم الأمور ويرحل من البيت ليتفرغ للدراسة في الأسبوعين الأخيرين فلم يكن قادراً على المقاومة وكبح مشاعره وغرائزه المتدفقة ، كيف لا وهو القادم من القرية ومن أغوار الحرمان وهو المتعطش للرومانسية والحب. فانجرف في هذا التيار منقاداً بمقود عواطفه وغرائزه ، سابحاً تارة ومتخبطاً تارة أخرى يهدده الغرق والإستقرار بالقاع .
ليته لم يقرر الرحيل ، فقد كان حبه لها جاداً وعميقاً وبكل الحواس والمشاعر ، فبعد الرحيل أصيب بصدمة عاطفية لم يقو على مقاومتها فأخذ يعاني من لواعج الفرقة ، وآلام البعد عن الحبيبة ، فزاده البعد عنها بعداً عن الواقع الذي أيقظه من غيبوبته ، وزاده قرباً من الخيال والسراب والهيمان وعانى من الحرمان من الوصال بعد اتصال كان ميسراً وسهل المنال ، يحوم حول بيتها ولا يستطيع التواصل معها برفض من داخله تنفيذاً لقرار صعب اتخذه ولا رجعة فيه، فلم يعد يذق للنوم طعماَ ، وارتبك في دراسة المواد ومراجعتها ، فأخذ يتصفح الكتب المقررة وكأنه حديث العهد بها ، يمر عليها مرور الكرام ويتذكر ما سمعه من الشرح وعقله مشدود للخلف وفكره مشغول بالحبيبة الضائعة وذكرياته معها، وراجع بسرعة بعض المواد الهامة وسط الذهول من انقطاع حبل الوصال مع الحبيبة المستحيلة باختلاف الديانة، ومن مفاجأة الإمتحان مثله كساعٍ الى الهيجا بدون سلاح. وكان يلهج بدراسته ويسابق الزمن من أجل النجاح ، أدرك أنه لن يحقق طموحه وطموح أهله ، فهبط سقف توقعاته من أن يحصل على معدلٍ يوازي إمكاناته العقلية والذهنية ، وأيقن أنه أهدر وقته وطاقاته وأسلحته لخوض المعركة ، وأخذت الأفكار تتصارع في عقله ، تارة يفكر بالإستمرار ، وتارة أخرى بالإنسحاب ، وأصبحت مشكلته هي تبرير النتائج في كلا الحالتين ، أصبح يعاني من قلة النوم وانعدام الشهية للأكل والرغبة في الإنسحاب من الحياة ، ومن زحمة الأفكار وتصارعها ، ومن محاسبة النفس واللوم على التقصير ، وخوفه من مواجهة طموحات أهله وآمالهم فيه ، ومن الشوق واللواعج للقاء الحبيبة ، ويبدو أنه كان الإنهيار في الثقة بالنفس تجاه الإمتحانات والإنهيار العصبي ، وأخيراً دنا موعد الإمتحان ، وتحت وطأة الضغوط عليه من كل الجوانب والإتجاهات برَّر لأهله بأنه يعاني من مرض عضوي في معدته لا يمكنه من الدراسة ولا يستطيع الأكل ، وأخذه أهله للطبيب فوصف له دواءً للمعدة ، ولكنه يدرك كنه ما ألم به ، فأبدي وتظاهر بعدم استجابته للعلاج ، فأخذوه الى طبيب آخر ، وأصبح يتردد على عيادات الأطباء ، وأخبر أهله بأنه سينسحب من الإمتحان ولن يذهب لتقديم الإمتحانات وسيعيد التوجيهي في السنة المقبلة ، ولكنهم طلبوا منه الإستمرار وأخبروه بأنهم سيقبلون بأي نتيجة كانت ، وتولد لأهله شعورٌ وتيقنوا بأنها عين الحسود التي أصابته ، وأوصلوا له الفكرة ، وقد ولدت في نفسه راحة وأوجدت له تبريراً لما يحصل معه ، وطلبوا منه أن يذهب معهم للشيوخ والفتاحات للقراءة عليه ، فسايرهم وهو بداخله يرفض هذه الأفكار ويعلم جيداً ما أصابه. وكان والداه يسهران عليه الليالي الطوال قبل وخلال الإمتحانات وهو يتظاهر أمامهما بالآلام العضوية الحادة في بطنه ، وفي صبيحة أول يوم ذهب للإمتحان منهك الجسم ، متثاقلاً في مشيته وهزيلاً ونحيفاً ومحبطاً ويائساً ومشوشاً في بصيرته ، وأمضى فترة الإمتحان بهواجس الرسوب ، فكلما أكمل مادة واطمأن على نجاحه بها من واقع الإجابات ، يبدأ التفكير في المادة المقبلة ، وينتابه شعورٌ يتحول الى يقين بالرسوب في تلك المادة ، فينهشه شبح المادة بالخوف ويصيبه الأرق والقلق ، ولم تكن ذاكرته القوية تسعفه بمخزونها الضئيل عن تلك المادة لقلة الدراسة والمتابعة ، فيتصور أنه لا يحفظ أو يتذكر منها شيئاً. ويدخل الإمتحان ويؤديه في ساعة أو أقل يُفرِّغ ما لديه من معلومات ويخرج ، لا يراجع ولا ينتظر لعله يتذكر شيئاً يضيفه ، فقد قرر في نفسه أنه سيرسب وسيعيد التوجيهي. وانتهت الإمتحانات وأخذ ينتظر النتيجة ويتمنى الرسوب لإعادة الإمتحان في السنة المقبلة مستفيداً من تجربته المتعثرة ، وكان يوم إعلان النتائج ، وجلس أهله بجانب الراديو يستمعون للنتائج ، وقد ضربوا كفاً بكف عندما لم يسمعوا اسمه من العشرة الأوائل وفي قرارة أنفسهم أنه لولا العين والحسد لكان من ضمنهم. وأخيراً سمعوا اسمه من الناجحين ، فانطلقت البنادق تطلق الرصاص في الهواء فرحة بنجاح جاء من هبة السماء ، ولكنه لم يفرح لتوقعه الحصول على معدل دون المستوى المطلوب لدخول الكلية التي ينشدها وهي كلية الطب كخيار أول أو الهندسة كخيارٍ ثانٍ ليحقق طموح وتمنيات أهله المتعطشين لذلك والمنتظرين له بفارغ الصبر. وخلال انتظار النتائج أخذ يستعيد عافيته العاطفية والذهنية بعد مراجعة جادة مع النفس.
في اليوم التالي ذهب يوسف للمدرسة لإحضار كشف العلامات ، لقد فوجيء بالمعدل ، لقد حصل على معدل 86% ، فقد حصل على علامة شبه كاملة بالرياضيات ، وعلامة عالية نسبياً في المواد العلمية (فيزياء وكيمياء( وعلامة متوسطة في الأحياء وعلامة شبه كاملة في اللغة الإنجليزية ، ومما خفض من معدله حصوله على علامات متدنية ومتوسطة في مواد الحفظ والمواد الأدبية، وكانت ظروف أهله المادية لا تسمح بدراسته في الخارج على حسابهم ، ولم يكن بالجامعة الأردنية كليةً للطب أو الهندسة ، فسجل في كلية العلوم ، وحصل على معدل عالٍ في السنة الآولى يتناسب مع قدراته بعد أن تخلص من ذكريات الماضي، وانكب على الدراسة ليعوض ما فاته وأهّله معدله في الجامعة ليحول من كلية العلوم الى كلية الطب التي افتتحت في ذلك العام ، وانتظم بكلية الطب جاداً ومهتماً بدراسته مستفيداً من أخطاء الماضي وانزلاقاته الخطرة ، وكان يحصل على قروض من صندوق إقراض الطلبة كل عام ، وتقشف في مصاريفه ليهوِّن على أهله ولم يكلفهم شيئاً ، وتخرج وكان الأول على الدفعة ، فقدم أوراقه لجامعة أمريكية بتوصية من دكتور أمريكي كان معاراً من تلك الجامعة للجامعة الأردنية وكان مشرفاً على بحث التخرج الذي أعدّه يوسف ، فالتقطوه فوراً وهيئوا له وسائل البحث ، وأعطوه سكناً فاخراً ودخلاً عالياً ، وهو الآن من اطباء جراحة القلب المشهورين هناك. وفكر بالعودة للجامعة الأردنية ودفعوا له راتباً شهرياً لا يساوي دخله في نصف يوم واحد في أمريكا. وقرر البقاء هناك وحصل على الجنسية الأمريكية ويعيش عيشة الأثرياء ويعمل بالبحث في االعلوم الطبية والدوائية ويمارس هوايته بالأدب والثقافة.
لم يلتق الصديقان اللدودان منذ أن افترقا عام 1971 ، ومضى الدهر متسارعاً يغير بشكليهما ومظهريهما ، الى أن جاء يوم في منتصف عام 2006م ، كلفت الجامعة الأستاذ الدكتور علي بالسفر الى الولايات المتحدة لتمثيلها في مؤتمر عقد هناك ، واستقل الطائرة من بيروت متوجهاً الى أمريكا عبر جنيف ، وفي مطار جنيف نزل بعض الركاب وصعد آخرون ، وكان من الصاعدين الطبيب الأستاذ الدكتور يوسف ، وجلس يوسف بجانب علي ، وقد تهيأ لكل منهما أنه يعرف الآخر ، فقد التبس عليهما الأمر وراودهما الشك ، وعاد يوسف بذاكرته القوية للوراء يستعرض شريط حياته ، ويبدو أن الشك لديه تحول الى شبه يقين بأنه يجلس بجانب صديقه اللدود ، فطلب من جاره في المقعد أن يتعارفا لتأكيد ظنه الذي تيقن منه ، وكانت المفاجأة السعيدة لكليهما ، وقاما وتعانقا طويلاً ، وأمضيا الرحلة في استعراض لماضيهما وذكرياتهما ، واتفقا على التواصل بكل الوسائل. وعادا صديقين حميمين يتواصلان باستمرار وبما يتاح لهما من فرص اللقاء.
بقلم أحمد ابراهيم الحاج
25/10/2008







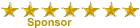




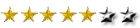

» صيانة سخانات في دبي 0543747022 emiratefix.com
» تركيب و تصليح سخانات مركزية في عجمان 0543747022
» تركيب و تصليح سخانات مركزية في عجمان 0543747022
» تصليح أفران في دبي 0543747022 emiratefix.com
» تصليح أفران في دبي 0543747022 emiratefix.com
» تصليح ثلاجات في دبي emiratefix.com 0543747022
» تصليح سخانات في دبي - 0543747022 (الشمسية و المركزية) emiratefix.com
» تركيب و تصليح سخانات مركزية في الشارقة 0543747022
» اداة ذكاء اصطناعي للباحثين وطلاب الدراسات العليا